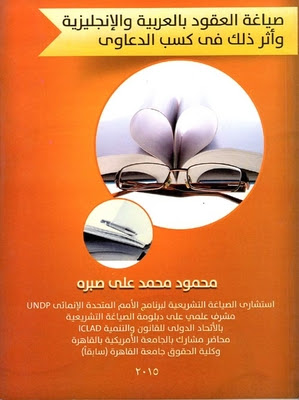ربما استوقفك طول عنوان هذا الكتاب إلى حدٍ
ما مقارنة بغيره من الكتب، ولربما تعجبتَ لِمَ لم يكتفِ المؤلف بعنوان "صياغة
العقود بالعربية والإنجليزية"، ولعل في سبب اختيار مؤلف الكتاب وفارس الميدان
الأستاذ الدكتور محمود محمد علي صبره لهذا العنوان تحديدًا "صياغة
العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى" إشارة واضحة إلى
التأكيد على ما للصياغة القانونية الجيدة والمُحكمة من أثر في كسب الدعاوى
القانونية؛ فما للصياغة، في أي فن من فنون العلم، من أهمية تُذكر إذا هي لم تُؤتِ ثمارها المرجوة منها، ولا سيما عند الحديث عن اللغة القانونية التي تُصاغ فقراتها
وجملها وعباراتها بل وكلماتها وألفاظها وأحيانًا حروفها وعلامات الترقيم بها
بعناية بالغة لما قد تُحدثه من أثر بالغ في سير القضايا والدعاوى القانونية، ناهيك
عن أن يكون مؤلف الكتاب نفسه استشاريًا متخصصًا وباحثًا متبحرًا في فن الصياغة القانونية
عامة والصياغة التشريعية خاصة، ولا ينبئك مثل خبير.
منهج الكتاب
حين يناقش الكاتب
في مؤلَفه صياغة العقود العربية والإنجليزية وأثرها في كسب الدعاوى إنما يهدف في
المقام الأول إلى محاولة وضع منهج علمي وبلورته بما يشرح كيفية صياغة العقود
باللغتين، وبذلك يكون منهج الكتاب من ذلك النوع من الدراسات التي يندر وجود مثلها
مما يتناول موضوع صياغة العقود من منظور شامل ومن عدة زوايا وباللغتين العربية
والإنجليزية معًا وفقًا لمنهج علمي محدد؛ ومن ثم فالمنهج العلمي المتبع في الكتاب
هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعطي فيه الباحث عند مناقشة كل موضوع خلفية عنه
يعقبها وصف لعناصره والمبادئ القانونية التي تحكمه ثم يحلل تلك العناصر مع إعطاء
أمثلة إيضاحية لكل منها.
استعراض لفصول
الكتاب
يبدأ المؤلف كتابه
بخطة الدراسة موضحًا موضوعها وحدودها ومنهجها ومحتوياتها ومجيبًا في الوقت نفسه على
السؤال الذي يطرح نفسه حول أهمية دراسة موضوع صياغة العقود من الأساس، وبعد خطة
الدراسة التي تحدد معالم الكتاب الرئيسية، ينقسم الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول
وخاتمة؛ ونظرًا لأن الباحث في هذه الدراسة ومؤلف الكتاب هو أستاذ الصياغة وفارسها،
فلن نجد أفضل من صيغة استعراضه بنفسه لفصول الكتاب لننقلها كما صاغها كما هي في ثنايا
السطور التالية مع تصرف يسير لتحل كلمة "الكتاب" محل "الدراسة و"الكاتب" محل "الباحث".
تناقش المقدمة مفهوم
العقد وتمييزه عن الاتفاق والصك، كما تتعقب نشأته وتطوره؛ ولأن الدراسة تركز على
صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية، كان لا بد من إعطاء خلفية عن المفاهيم
القانونية في نظامي التقنين المدني والقانون العام، باعتبار أن هذه المفاهيم تؤثر
في صياغة بنود العقد وتفسيرها، وتنتهي المقدمة بتوضيح أنواع العقود وتقسيماتها.
ولأن العقد لا ينشأ
من فراغ، وإنما يكون نتيجة لمفاوضات يتحدد من خلالها مضمون بنوده، يلقى الكتاب في
المبحث الأول من الفصل الأول الضوء على مرحلة التفاوض التعاقدي، وفيه يقف الكاتب
عند مفهوم التفاوض التعاقدي والمبادئ التي تحكم تلك المرحلة، وقد راعى مناقشة هذه
المبادئ تحت عناوين أشبه ما تكون بعناوين الأفلام السينمائية أو القصص الروائية،
مثل "الصيغة الذهبية" و"حرب النماذج" و"الضربة
القاضية" و"تبادل الطلقات في أثناء المعركة"، ورغم أن هذه العناوين
اختيرت بسبب جاذبيتها، فمن المثير للدهشة أنها شائعة بالفعل في الأدبيات التي
تناقش العقود ولم يبتدعها الكاتب، وفي المبحث الثاني من الفصل الأول، يتناول
الكتاب العقود التي تسبق إبرام العقد النهائي، ورغم أن الهدف من بعض هذه العقود هو
تنظيم المفاوضات أو مجرد التمهيد لإبرام العقد النهائي، وإن لم تكن ملزمة للطرفين
بتوقيعه، فثمة عقود تُعد شبه نهائية وأخرى نهائية؛ ولذلك يناقش هذا المبحث العقود
التي تسبق إبرام العقد النهائي في أربعة مطالب؛ يناقش الأول عقود التفاوض والثاني
العقود التمهيدية للتعاقد النهائي والثالث العقود شبه النهائية والرابع العقد
الابتدائي (الذي يُعد كامل الأركان، كما يوضح المؤلف بين سطور الكتاب).
ويناقش الفصل
الثاني أركان العقد في مبحثين، خصص أولهما لبحث الأركان الشكلية، وثانيهما لبحث
الأركان الموضوعية، يلقي الأول الضوء على مفهوم الشكليات ووظائفها وارتباط الشكل
بصحة العقد ونفاذه، وينتهي ببحث العناصر الشكلية للعقد والتي تمثل أركانه الشكلية،
وهي الكتابة والتوقيع والختم وتبادل وثائقه، في حين يناقش الثاني أركان العقد
الموضوعية وهي التراضي والسبب (أو المقابل) والمحل والنية للتعاقد.
وخصص الفصل الثالث
لمناقشة تصميم العقد، وينقسم إلى مبحثين، الأول يتناول البنية العامة للعقد ويوضح
أن التنظيم الجيد للعقد يضمن تنفيذه الفعال، كما يلقي الضوء على عناصر التنظيم
بشكل عام، أما الثاني، فيدرس أجزاء العقد والخصائص المميزة لكل جزء.
ويناقش الفصل
الرابع صياغة بنود العقد، وينقسم إلى أربعة مباحث؛ خصص الأول منها لبحث بنود أركان
العقد والثاني لالتزامات الأطراف بخلاف الدفع والثالث للبنود النموذجية في العقود
والرابع لبنود الإعفاء من المسؤولية، ويمثل هذا الفصل جوهر الكتاب؛ ولذلك يناقش كل
مجموعة من البنود باستفاضة من ناحية المبادئ القانونية التي تحكم صياغة كل بند
والاتجاهات الحديثة في صياغة هذه البنود مع إعطاء أمثلة إيضاحية لتلك المبادئ
واقتراح صياغة نموذجية لها باللغتين العربية والإنجليزية.
ويناقش الفصل
الخامس والأخير تقييم العقد في مبحثين، خصص الأول منهما لبحث عناصر التقييم
وأدواته ويركز على معايير التقييم وطرق سد الثغرات والتأكد من كفاية العقد، في حين
يقدم الثاني دليلًا توجيهيًا لتقييم العقد، ويتكون هذا الدليل من ملاحظات عامة
وقائمة فحص وتوجيهات يُنصح باتباعها عند مراجعة العقود.. وأخيرًا، تلخص الخاتمة ما
تمت مناقشته في هذا الكتاب في حدود الغرض منها ونطاقها، وقد حاول الكاتب في هذا
الكتاب، قدر استطاعته، تغطية كل عناصرها.
وإلى هنا ينتهي
استعراض المؤلف لمؤلَفه لتبقى لنا كلمة أخيرة للتعليق على هذا الكتاب باعتباره من
أهم المراجع التي لا غنى عنها لأي مترجم عامة ولأي مترجم قانوني خاصة ولأي مترجم
متخصص في ترجمة العقود القانونية على وجه التحديد؛ فالكتاب غني بالتعريفات
والمفاهيم والمصطلحات القانونية الجوهرية في كل ما يتعلق بصياغة العقود حيث أراد
منه مؤلفه أن يكون مرجعًا شاملًا في موضوعه، كما يمتاز الكتاب بتسلسله المنطقي
للموضوعات التي يطرحها الكاتب بكل براعة فضلًا عن غزارة المحتوى القانوني والتزامه
المنهج العلمي التحليلي بإتقان، ويأتي كل هذا مدعومًا بنماذج عملية وصيغ ثنائية
اللغة متنوعة للعديد من العقود والبنود مع شرحٍ قانوني تحليلي وافٍ لها... وخلاصة
القول في هذا الكتاب القيِّم وتلك الدراسة العلمية الرصينة، أن الكاتب وضع بين يدي
القارئ عامة والمترجم خاصة كنزًا من كنوز الترجمة القانونية عامة وصياغة العقود
خاصة؛ فهو بحق من أفضل المراجع اللغوية والقانونية والترجمية وأقيّمها في مجال
صياغة العقود القانونية.
سطور من الكتاب
"وقد جرت
العادة في اللغة العربية على استخدام كلمة "عقد" بدلًا من كلمة
"اتفاق" في العقود المسماة، حتى ولو كان موضوع الالتزام مُتفَقًا على
تنفيذه في وقتٍ ما في المستقبل، ومن النادر أن تجد مَنْ يستخدم مصطلح "اتفاق
إيجار" أو "اتفاق عمل" وما إلى ذلك، وإنما الشائع استخدام
"عقد إيجار" و"عقد عمل" إلخ...؛ ولذلك فإننا نطمئن تمامًا إلى
ترجمة كلمة Agreement في عناوين
العقود بكلمة "عقد"."
"رغم أن مسمى "مواد العقد" (Contract Articles) أكثر شيوعًا في الدول العربية من مسمى "بنود العقد" (Contract Clauses)، فإن مصطلح
"بند" (Clouse) هو الأكثر شيوعًا في العقود التي تُكتب
باللغة الإنجليزية، ولا يُستخدم مصطلح "مادة" (Article) إلا عند
الإشارة إلى المعاهدات الدولية أو لوائح وتوجيهات المجموعة الأوروبية."
"تتضمن العقود، لا سيما الطويلة منها، بندًا للتعريفات Definitions يتضمن شرحًا
لمعاني الكلمات والعبارات الواردة في العقد، والتي قد يثور خلاف حول معناها... في
حين يضع بند التفسيرات interpretations قواعد واضحة تسري عند تفسير
العقد، ويهدف هذا البند إلى تحقيق اليقين بين الطرفين فيما يتعلق بالمصطلحات التي
يتضمنها بحيث لا يثور خلاف بينهما بشأنها عند تطبيق العقد، من ناحية، وتفادي
الحاجة إلى تكرار المقصود بتلك المصطلحات من ناحية أخرى." (بإيجاز)
بطاقة التعريف بالكتاب
الكتاب: صياغة
العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى
الكاتب: محمود محمد
علي صبره
عدد الصفحات: 494
ناشر الكتاب في طبعته الأولى: المؤلف
تاريخ النشر للطبعة الأولى: 2005